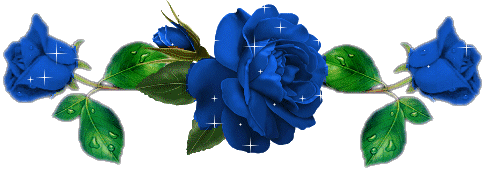وصية الله -سبحانه وتعالى- في كل آن وحين للأولين والآخرين تقواه -سبحانه وتعالى-، وهي زادهم يوم لقاء رب العالمين: (وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ) [البقرة:197].
قصة رمزية طالعتها فلفتت نظري، ورأيت أن الابتداء والاستنباط منها حري أن يكون موضوعاً له أهمية وفائدة كبيرة.
شاب يقود دراجته اصطدم بامرأة عجوز فسقطت على الأرض، بدلاً من أن يساعدها ويعتذر لها انفجر من هذا المنظر ضاحكاً ومضى على دراجته سائقا، فصاحت به: انتبه لقد سقط منك شي! فرجع الشاب وظل ينظر ويبحث! فقالت له: لا تنظر، لقد سقطت مروءتك، ولن تجدها أبدا!.
ربما تكون القصة مبتكرة ليست حقيقية، لكن دلالتها على أمرين مهمين في واقع حياتنا الفردية والاجتماعية والأممية: الاستهتار بالقدر والمقدار، والاستكبار على الاعتراف بالخطأ والاعتذار. وكم نجد ذلك في كثير من حوادث وتطبيقات حياتنا ومجتمعاتنا!.
كلما كان للمرء -بحسب النظرة الاجتماعية الموجودة- منزلة أعلى ورتبة أكبر كلما كان التفاتُه إلى غيره قليلاً أو منعدماً، فحاكم يستهتر بشعبه، ومدير يستهزئ بموظفيه، ومعلم يقرّع طلابه، وأب يسفّه أبناءه.
صور نراها هنا وهناك، وليست صوراً خياليا، فقد سمعنا من يطلق على جماهير شعبه بأنهم جرذان! ومن يصفهم بأنهم مْنْدَسِّين! ومن يتهمهم بأنهم متآمرون!
وقد رأينا كثيراً مسئولين كباراً كلما وقع خطأ جسيم بسهولة وببرودة أعصاب وبلادة إحساس يلقون التهمة على صغار الموظفين هنا وهناك!.
وعندما يقع المدرس في خطأ فإنه بدلاً من أن يعترف بالخطأ أو يتواضع للعلم؛ فإنه يشن هجومه مستهتراً مستهزئاً ضارباً عرض الحائط بكل أساليب التربية والتعليم؛ لأنه ينتصر لنفسه؛ لأنه لديه شي من القوة والسطوة والسلطة، فلا يعطي الآخر حقَّه من الكرامة، ولا مكانه ومقداره من الاحترام اللازم له، ومثل ذلك -كما قلت- يقع في الأُسَر وبين الأبناء.
أما مسألة الاعتراف بالخطأ والاعتذار عنه فتلك مهمة أكثر صعوبة، لا يبلغها إلا الرجال الحقيقيون، الذين لا يستنكفون عن أن يُقِرُّوا بأخطائهم، ويعترفوا بتقصيرهم، لا يرون في ذلك ذلاً، بل يرونه عزا، ولا يرون فيه قصوراً، بل يرونه كمالا.
وحسبنا هنا أن نقف وقَفاتٍ مع هذه الحقيقة المهمة، حقيقة الاعتذار الذي يتضمن الاعتراف بالخطأ، والرجوع إلى الحق، والإحساس بالندم، وإعطاء الآخرين حقهم في الاعتذار إليهم، وطلب السماح منهم في نفسية ملؤها التواضع يشع منها التسامح، وتفيض رقة ودماثة خلق، ليست فيها كبرياء وغطرسة، ليست فيها فظاظة وقسوة.
وَلَعَمْري! لقد أوجز وأبلغ، بل أعجز رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عندما وصف الكِبْرَ بجملتين عظيمتين فقال: "الكبر بطر الحق، وغمط الناس"، استعلاء عن الحق، وعدم قبول به، عدم إذعان له، عدم إقرار بأنه يحكم ولا يستثنى من حكمه أحداً.
الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني – المصدر: صحيح الأدب المفرد – الصفحة أو الرقم: 433
خلاصة حكم المحدث: صحيح
وغمط الناس ازدراؤهم، احتقارهم، انتقاص مكانتهم وامتهان كرامتهم، وتلك سمة هي أرذل السمات، بها يكون سبب حرمان الجنة: "لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر"
الراوي: عبدالله بن مسعود المحدث: الألباني – المصدر: صحيح الترمذي – الصفحة أو الرقم: 1999
خلاصة حكم المحدث: صحيح
ولنرجع إلى البداية الأولى لنرى المشهد في طريقين مختلفين، ومسارين متعارضين، المشهد الأول لإبليس -عليه لعنة الله- أُمر بالسجود فأبى، وإليكم المشهد في آيات موجزة معجزة: (قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ) [ص:75]، وجاء الجواب: (قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ) [ص:76].
لا اعتراف بالحق، لا رجوع إلى الصواب، لا اعتذار عن هذا التجاوز: ( فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ * وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ) [ص:77-78]
ومَن نهَج هذا النهج أخذ بالجريمة والكبيرة الأولى في الحياة الإنسانية، وهي جريمة ومعصية الكبر، الاستكبار الذي يجعل النفس لا ترى شيئاً غيرها، يجعل المرء لا يرى أحداً إلا وهو دونه في كل مجال، وفي سائر الأحوال.
وانظر -رحمك الله- إلى الصورة الأخرى، الصورة التي ننتسب إليها من حيث أصل الخلقة البشرية، وننتسب إليها من حيث النسب والرحم الإيماني والإسلامي، في قصة آدم -عليه السلام- عندما أمره الله -عز وجل- وزوجه بألَّا يأكلا من الشجرة: (فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ) [الأعراف:22]
وهنا النموذج المثالي للإنسان بفطرته البشرية، فضلاً عن إيمانه وإسلامه: (قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ) [الأعراف:23].
(أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ)، ما كانت ثمة مراوغة ولا مجادلة ولا مكابرة، وإنما إقرار واعتذار واستغفار، وهذا هو النهج من البداية: إما سبيل كأنما هو في اتِّباع خطوات الشيطان بالكبر والمكابرة والمراوغة والمجادلة، وإما سبيل على خُطى أبي الأنبياء وأبي البشر آدم -عليه السلام- بالإقرار والاستغفار والاعتذار لما هي في طبيعة النفس البشرية من وقوع في الخطأ: "كُلُّ ابنِ آدمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الخطَّائينَ التوَّابون".
الراوي: أنس بن مالك المحدث: الألباني- المصدر: صحيح الترغيب – الصفحة أو الرقم: 3139
خلاصة حكم المحدث: حسن
وعلى الطريق قمم عظيمة شامخة، رسل وأنبياء، قادة وأصفياء، موسى -عليه السلام- وكز الرجل فقتله في لحظة من غضب واستخدام للقوة، وفي لحظة مباشرة من طبيعة بشرية سوية: (قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ) [القصص:15]، ثم توجه إلى الله -سبحانه وتعالى-: (قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ)[القصص:16].
يونس في بطن الحوت: (لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ) [الأنبياء:87].
سيد الخلق -صلى الله عليه وسلم- تنزلت الآيات تُعاتبه في أعمى، في ابن أم مكتوم: (عَبَسَ وَتَوَلَّى * أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى) [عبس:1-2]، فكان إذا جاء عبد الله بن أم مكتوم كان النبي يقول: "مرحباً بمن عاتبني فيه ربي!"، بأبي هو وأمي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-!.
وعند مسلم من حديث طلحة بن عبيد الله أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان معه، فمروا على قوم في رؤوس النخل يأبرون، قال: "ما يفعل هؤلاء؟"، قال: يلقحونه، يأخذون من الذكر للأنثى فيلقحونه، قال: "ما أظن ذلك يغني عنهم شيئاً"، فتركه الناس، فأُخبر النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ فماذا قال عندما عرف طبيعة هذه المهمة؟ قال: "إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظناً، فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئاً، فخذوه، فإني لن أكذب على الله -عز وجل-".
وصور مشرقة يقدمها لنا القرآن في غير دائرة الرسل والأنبياء، من أمثالنا من البشر العاديين، حتى يكون لنا في ذلك عظة وعبرة، ومن أعظم ذلك وأبرزه في سورة فريدة نادرة، وجرأة نفسية قوية، وسمو أخلاقي في لحظة من لحظات الاعتراف والاعتذار، في قصة يوسف -عليه السلام- وامرأة العزيز، عندما تكشفت الأوراق، وظهرت الحقائق؛ فبكل جرأة، ورباطة جأش، وثقة بالنفس، وإقرار بالخطأ، وإحساس بالندم، ورجوع إلى الحق، قالت: (الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ) [يوسف:51]، هكذا! أمام الملأ في مسالة دقيقة حساسة؛ لأن النفس إذا جاشت فيها معاني الندم وظهور الخطأ تملَّكَها من الجرأة والقوة ما يدفعها إلى اعترافٍ ظاهرٍ بدون مواربة بالخطأ.
وانظروا إلى مشهد في سيرة المصطفى -صلى الله عليه وسلم- في غزوة تبوك، يوم تخلف جمع من المنافقين، ونفر قليل من الأخيار أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، جاء المنافقون يعتذرون ويلفقون ويكذبون، والرسول -صلى الله عليه وسلم- يقبل منهم ويعرض عنهم.
وجاء كعب بن مالك وقال: والله إني لأعلم إن قلتُ له قولاً أسلَم به لَيُوشِكنَّ الله أن يخبره به فأهلك، والله لا أجد إلا الصدق مخرجاً. فجاء مُقراً معترفاً معتذراً: يا رسول الله! والله ما كنت في يوم أقدر مني على اللحاق بك مني يوم ذاك، ولكني تخلفت. فقالها النبي -صلى الله عليه وسلم- كلمات مشرقة: "أما صاحبكم فصدق، فامضِ حتى يقضي الله فيك"، ودلالة كلمته أن من سبقه كلهم كاذبون، وإن لم يقل ذلك المصطفى تعففاً وترفعاً عن هذا المقام.
وجاءت الأحداث كما تعرفون، وقوطع أولئك النفر، ثم خلّد الله -سبحانه وتعالى- موقفهم وصدقهم، وضمهم في توبتهم مع الرسول والأنصار والمهاجرين، فقال:(وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا) [التوبة:118].
كم نحن في حاجة إلى أن نروض أنفسنا على الإقرار والاعتراف بالخطأ؟
وأول دائرة في ذلك دائرة اعتراف العبد لربه، واستغفاره من ذنبه، واعتصامه والتجائه وانطراحه بين يدي ربه، ويكفينا في ذلك أن الله -جل وعلا- دعانا دعوة تيسر لنا هذا الإقبال عليه، والاعتراف بين يديه، والانكسار له: (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا) [الزمر:53]
هو الذي يدعونا -سبحانه وتعالى-: (وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [النور:31].
وهذه دعوة من الله -سبحانه وتعالى-: (وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا) [النساء:64].
يوم نبدأ هنا في هذا المسار سوف تتروض نفوسنا أن تذل للحق، وأن تقر بأنه أحق أن يتبع، وأن تذعن لمن معه الحق وإن كان بغيضاً لها، أو موافقاً لها؛ لأن الحقَّ أحقُّ أن يُتَّبع.
ومن هنا -معاشر الإخوة الكرام- إذا نظرنا إلى هذا المعنى وهذه الحادثة وجدنا أن مبدأ الاعتراف بالخطأ، وإعلان الاعتذار، يكاد يكون أمراً قليلاً ضئيلاً، أو منعدماً لا وجود له.
واذكر هنا أيضاً قصة كتبها أحدهم في مقالة، ذكر فيها أنه ذهب إلى اليابان، وأنه كان مع رفيقه الياباني لركوب أسرع قطار في العالم يسمونه: الطلقة، فأخذ التذاكر، ووقفوا في المكان المحدد، وجاء القطار على وقته بالدقة المتناهية، وعندما توقف كانت البوابة متجاوزة ببعض سنتيمترات المكان المخصص لها، تبسم العربي وقال وهو يداعب صاحبه: لماذا تقدم قطاركم ولم يكن في الموقف المحدد! وعندما دخلوا فوجئ بأن الياباني يعتذر له ويقول: هذه حادثة لا أظنها حصلت، ولا بد أن أُكلِّم فيها المسؤولين عن القطار، وبدأ يكلمهم ويأتون إليه ويعتذرون، وعندما وصل إلى المحطة وجد مدير المحطة الأخرى يعتذر له، ويخبره بأنه ستكون هناك مراجعة ومحاسبة ومعرفة للسبب الذي وقع لأجله هذا الخطأ!.
ولا أظنني أحتاج إلى أن أضرب أمثلة، عندما تتأخر الطائرات بالساعات، ولا تجد أحداً يخبرك بتأخرها، فضلاً عن أن يعتذر لك، وإذا استمعت بعد ذلك في الطائرة فإنك تسمع الاعتذار باللغة الإنجليزية، وإذا تحدث بالعربية طوى الاعتذار؛ لأنه يريد أن يوصل اعتذراً لمن يفقهونه، أو لمن يستحقونه على أقل تقدير في نظره!.
ومن هنا نرى المصائب الكبرى في ديارنا وبلادنا، ولا نجد أحداً يعترف بالخطأ أو يعتذر عنه، ونحن نرى أن مسؤولين كباراً، ورؤساء حكومات، ربما يُثار حولهم شيء من الشبهات على مال ربما ننفقه نحن في وجبة في الإفطار أو نحوها، وإذا بالواحد منهم يعتذر ويستقيل من منصبه.
وعلى حد علمي منذ أن ولدت إلى هذا العمر لم أرَ أحداً يستقيل من منصبه في ديارنا وعالمنا العربي إلا أن يكون مكرها! لماذا؟
ونحن الذين علَّمَنا القرآنُ ذلك، وعرفنا كيف نكون أتباعاً للحق، وأن نكون سائرين على النهج، وأن نكون متبعين لسيد الخلق -صلى الله عليه وسلم-، وهو الهين اللين الذي كان يدعو الناس أن يذكروا له إن كان تجاوز في حقهم، أو اعتدى عليهم، أو أخطأ، وحاشاه أن يكون كذلك! أو أن يفعل ذلك! صلى الله عليه وسلم.
الخطبة الثانية:
أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله فإن تقوى الله أعظم زاد يقدم به العبد على مولاه؛ وإن من التقوى الرجوع إلى الحق، والاعتراف بالذنب، وطلب الاستغفار من الله، والتحلل من الناس؛ لأن لصاحب الحق مقالاً، وله حق في أن يقتص، إن لم يجد حقه في الدنيا فيكون في الآخرة؛ وفي حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- في قصة حادثة الإفك قوله: "فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب، تاب الله عليه".
وكذلكم نفقه هنا مسألة مهمة، وهي أن البيئة والحاشية كثيراً ما تكون سبباً في قطع الطريق على الاعتراف بالخطأ والاعتذار منه، وأنا أحدثكم الآن وأذكر القصص كنت أرى بعضاً منكم يبتسم ويستحضر صوراً أعتقد أن أكثرنا كنا نستحضر صوراً لا تخصنا ولا ترتبط بنا، وكأننا لسنا معنيين بهذا الحديث، ولسنا ممن قد يستكبر عن الاعتراف بالخطأ، ولا يرضى بالاعتذار عنه.
وأقول: في الجملة كلنا ذاك في قليلٍ أو في كثيرٍ، فلا يبرّئ أحد منا نفسه، وإلا كيف نرى كل ذلك فيشؤ مجتمعنا؟ مَن الذي لا يفعل ذلك؟ مَن الذي يستكبر عن ذلك إن كنت أنا وأنت ممن يذعن للحق، ويلين له، ويعطي الناس حقهم، ويعتذر لهم، ويشيع بيننا حتى الأدب الراقي في الاعتذار والأسف ونحو ذلك؟.
نحن اليوم ننتظر موعداً على الساعة المعينة فيأتينا المتأخرون وهم مبتسمون وكأن شيئاً لم يحدث، ولا كلمة للاعتذار عن هذا التأخر، وإن طُولب بالاعتذار فإن هذه جريمة لا تغتفر، سيما إن كان هو المسؤول، وهو الذي سيدير هذا الاجتماع، فله الحق في أن يفعل ما يشاء، وأن لا يُسأل عن شيء بحال من الأحوال!.
وهذه صور كثيرة متكررة، وقد أخبرنا النبي -صلى الله عليه وسلم- في صورة معينة ما يدل على مثل هذا وهو البيئة المحيطة، لو أن كلا منا قال بأدب كلمة حق، ونبّه إلى ضرورة الاعتذار، وإلى ضرورة الاعتراف بالخطأ، فإن ذلك سيكون أمراً شائعاً.
نحن لا نربي أبناءنا على ذلك؛ لأنهم إذا اعترفوا بالخطأ لقوا الويل والثبور، وعظائم الأمور، فصاروا يتقنون فن المراوغة والمجادلة، بل ونعلمهم صنعة الكذب والاحتيال أحياناً؛ ليفروا من العقوبة التي نصنعها نحن ولا نعرف آثارها التربوية.
ومثل ذلك يقع أيضاً في مدارسنا وفي معاهدنا ونحو ذلك، وهنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه:"إذا أراد الله بالأمير خيراً جعل له وزير صدق، إن نسي ذكّره، وإن ذكر أعانه" وتتمة الحديث في عكس ذلك: "فإنه يكون له وزير كذب، إن نسي لم يذكّره، وإن ذكر لم يُعِنْهُ".
وهذه الحواشي التي نراها ليست عند الحكام والساسة، بل حتى عند المدراء والكبراء والأغنياء والوجهاء، يقطعون الطريق ويمنعون وصول الحقائق، وإن جاء ليتكلم أو ليعتذر أو ليقدم خطوة إيجابية قيل إن ذلك سيُنقِص قدرك، وإن ذلك سيُربِك أمرك، وإن ذلك سيكون له ويكون له…
حتى رأينا ما رأينا ونرى في هذه البلاد الآن من ذلك الظلم والجبروت والقتل الذي يستمر يوماً إثر يوم، رجالاً ونساءً، صغاراً وكباراً، والتهم جاهزة، والإعلام الكاذب المضلِّل يقدم المبررات، وليس هناك خطأ مطلقاً! وليس هناك إثم ارتكب! بل حتى من يتسبب في القتل يمتطي مرة أخرى منبره ويترحم على أرواح الشهداء الذين قتلهم! ولا يستبعد أيضاً أن يمشي في جنائزهم، وهذا الذي نراه قمة الاستكبار، إنها الصورة الفرعونية الطغيانية: (مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ) [غافر:29].
والمسألة تبدأ من أول الخليقة: (قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ) [الأعراف:23]، فمن لم يعترف بذنبه لربه، ومن لم يبك على خطيئته فيما بينه وبين خالقه؛ فإنه لن يكون بحال من الأحوال قادراً على أن يعترف للناس، أو يعتذر منهم، أو يقدم لهم ما يجب أن يقدمه لهم بما جنى عليهم، أو بما تسبب من الضر.
سلمت يمناكِ على النقل الهادف
جعله الله في موازين حسناتكِ
لا عدمنا روعه التميز
دمت لنا ودام تالقك الدائم

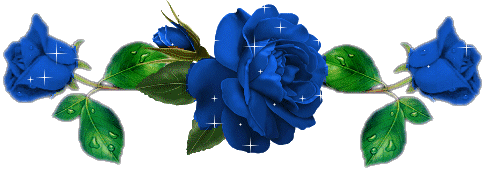
جزآك الله جنه عرضهآ السموآت والآض
وبآرك الله فيك على الطرح القيم
آسآل الله آن يزين حيآتك بـ الفعل الرشيد
ويجعل الفردوس مقرك بعد عمر مديد
دمتي بـ طآعة الله