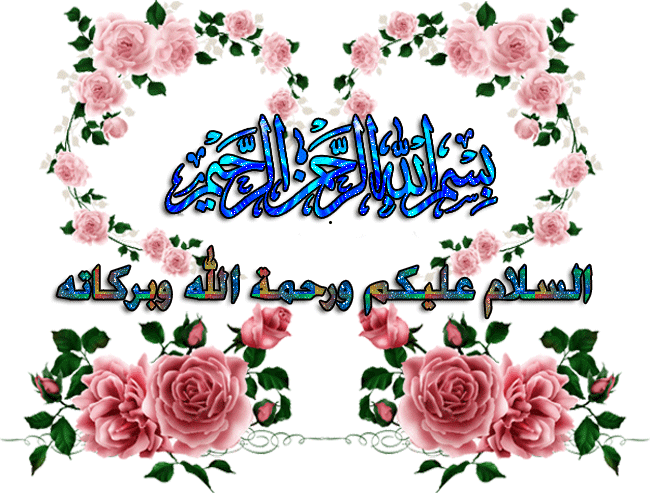إن ينصركم الله فلا غالب لكم
الشيخ على بن عمر بادحدح
الله جل وعلا يقول: {إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ}[آل عمران: 160].
هذه آية عظيمة من الآيات التي تتضمن سنة من سنن الله جل وعلا الماضية في هذه الحياة، وبادئ ذي بدء ظاهر أن المعنى الواضح من الآية ليس موضع شك ولا اعتراض ولا جهل من المسلمين المؤمنين المخاطبين بالآية فكل أحد يعلم أن الناصر هو الله عز وجل وأن نصره لا يرد، وإذا كان الأمر كذلك فإن في هذا الخبر القرآني معنى مراداً وقصداً مطلوباً، ويشبه ذلك أيضاً ما ورد في قوله جل وعلا: {مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ} [فاطر: 2] وهذا يعرفه الناس، إذاً فما المراد؟.
المراد هو أن هذا الخبر يتضمن أمرين متلازمين
أولهما التسلية والتسرية فإن الآيات قد جاءت أيضاً في سياق ما كان من أحداث غزوة أحد وما حل فيها بالمسلمين، فكأن الحق جل وعلا يسري عن المسلمين فيقول لهم إن ما قضاه الله جل وعلا من هذه الجولة التي كانت فيها للمشركين صولة فإنما هو بما قدره سبحانه وتعالى وإن في قدره حكمة بالغة وإن فيها نفعاً عظيماً وإن فيها تربية صالحة للأمة، ولذلك إذا أيقن المؤمنين بذلك كان لهم فيه أحسن عزاء وأعظم تسلية.
والأمر الثاني وهو تابع لهذا ومتصل به مباشرة وهو الأخذ بما يعرض المسلمين والبعد عما يوقعهم في الخذلان؛ لأنه إذا كان النصر من الله وإذا كان الخذلان أيضاً مرجعاً إلى تقديره سبحانه وتعالى فإذاً كأن القرآن يقول لنا معاشر المسلمين إن كنتم توقنون بأن النصر من الله فخذوا الأسباب التي توجب لكم نصره وتنزل عليكم تأييده وتمدكم بجنده كما فعل مع رسوله صلى الله عليه وسلم وكما كان مع المؤمنين في كل حال وآن، وكما وقع في أحد لمخالفة نفر قليل من الصحابة وهم الرماة الذين كانوا على الجبل، فاعلموا كذلك أنما قد يكون من مخالفاتكم ومن معاصيكم سيكون له أثر فاجتنبوا ذلك لئلا يحصل لكم ذلك.
فإذاً الخبر ليس مجرد إخبار وعلم وإنما هو إخبار يتضمن تسلية وتعزية بما يكون من قضاء الله وقدره ويتضمن طلباً من المسلمين بأن يأخذوا بأسباب النصر ويجتنبوا أسباب الخذلان من خلال طاعة الله والاستقامة، ومن خلال البعد عن مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. وهذا كما قال أهل التفسير يتعين أن يكون هذا الخبر ليس مراداً به مجرد الإخبار وإنما ما يتضمنه من هذا المعنى.
ومن هنا أيضاً نبدأ من نقطة ثانية فإن الآية فيها ترغيب في الطاعة وفيما يستحق به المسلمون النصر من الألفة والوحدة ونبذ الشقاق والخلاف؛ لأنه كأنما تغريهم بنصر الله فتحثهم حثاً قوياً وترغبهم ترغيباً أكيداً فيما يحصل بذلك، وفي الوقت نفسه يأتي التحذير المقابل لهذا.
ثم نأتي لقوله: {إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ}.
المعنى المراد: إن يرد الله نصركم وإن يرد الله خذلانكم، فالآية مربوطة بالإرادة كما في قوله: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6] ليس إذا وقفت في الصف وإنما إذا أردت التوجه إلى الصلاة فابتدر بالوضوء واغسل وجهك وافعل تلك الأفعال المقصودة بالوضوء.
{إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ} ونلاحظ هنا الصيغة بالفعل المضارع الذي يدل على الاستمرار حتى لا ننسى هذا ونلاحظ أيضاً فعل الشرط وجوابه الذي يدل على الاضطراد والاستمرار كذلك، ما هو النصر؟
هو: "الإعانة على الخلاص من غلبة العدو ومريد الإضرار" كما ذكر ابن عاشور في تفسيره، فالنصر هو تحقق مرادك لا مراد عدوك وحصول قصدك لا حصول قصده، وبالمقابل الخذلان هو الإمساك عن الإعانة على النصر مع القدرة، وهذا معنى جميل الإمساك عن الإعانة على النصر مع القدرة، الله عز وجل قدرته لا يحدها شيء وفي قدرته أن ينصر عباده المؤمنين في كل وقت وحين مهما كانت القوة التي تواجههم، فإذاً الخذلان هو ترك النصرة كما قال بعض أهل التفسير بهذا التعبير ترك النصرة أي أن الناصر سبحانه وتعالى موجود وقدرته موجودة وملائكته موجودة والريح التي يسخرها موجودة لكنه أمسك ذلك كله وترك إعانة أولئك بنصرهم وخذلهم لخذلانهم لأنهم بما كان منهم من معصية الله سبحانه وتعالى، ولذلك الخذلان هو غاية الترك، لأن هناك صور من الترك متفاوتة.
على سبيل المثال الإنسان يذنب ويخطئ ويعصي: (وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون)، بقدر هذه المعصية يكون شيء من ترك الله عز وجل لنصرته، أليس كذلك؟
لكنه إن بلغ مبلغاً كان فيه يعتقد أن هذه المعصية ليست معصية، وأن هذا الفعل مرغوب فيه أو مطلوب منه ولم يلتفت إلى الحرمة الشرعية فحينئذ يكون الخذلان أكبر، وضرب التستري في تفسيره مثالاً: آدم عليه السلام كما نص القرآن {وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى (121) ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى} [طه: 121، 122]
لماذا آدم عصى فجعل لمعصيته أثر وهو نزوله إلى الأرض لكن الله لا يتخلى لم يخذله لكن أُمر إبليس بالسجود لآدم فأبى واستكبر، وكانت عنده حجة: {أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ} [الأعراف: 12] {أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا} [الإسراء: 61] وهكذا فكان حينئذ خذلان بتركه كلية والله عز وجل عالم وقد قدّر ذلك لكن هذه الصورة هي التي تبين لنا الفرق بين مجرد معصية يتوب منها الإنسان أو معصية يقر فيها بالذنب ويندم عليها ويتمنى أن لو يخلصه منها وبين أمر يمارسه وهو مصر عليه ويقول إنه الأفضل وإن سواه ليس مرغوباً وليس مطلوباً وإنما تقولونه من هذه الأمور هو ضرب من الخيال ونوع من البعد عن الواقعية وغير ذلك هذا والعياذ بالله قد يكون فيه خذلان؛ لأنه مخالفة مع إصرار وربما يكون فيه معنى المخالفة مع التسويغ والتبرير.
{إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ} لم يقل فلا تغلبوا!
لماذا؟
لأن هذا المعنى الذي ذكرته الآية بهذه الألفاظ أعم وأشمل وهو أمر مضطرد لا يتخلف، ما معنى ذلك؟
معناه أنه لن تغلبوا لا في وقت من الأوقات ومهما كانت القوة التي تواجهكم ومهما كانت صورة ضعفكم؛ لأن الله أراد نصركم، فهو يسبب لذلك الأسباب قد يقذف الرعب في قلوب الأعداء، قد يجعل بأسهم بينهم، قد ينزل عليهم رجزاً من السماء، قد يزلزل الأرض تحت أقدامهم كل الأمور في قدرة الله عز وجل ممكنة، قال: {فَلَا غَالِبَ لَكُمْ} وقد قلنا من قبل إن اسم الفاعل هو الأدل على التمكن من الأمر، عندما نقول فلان كتب لا يعني أنه محترف في الكتابة لكن قلنا كاتب يعني أنه يجيد هذه الكتابة ويعرفها ويتقنها، {فَلَا غَالِبَ لَكُمْ} أي لن يكون هناك من يغلبكم بحال من الأحوال.
ولو لاحظنا وسننتقل الآن لمجرد المقارنة: {وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ} ما قال (فلا ناصر لكم) بل قال: {فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ} لأن الأمر هناك مختلف والإرادة الإلهية لا تتضمن في الآية أنه سيتخلى عن عباده ويخذلهم كالخذلان الذي رأيناه في قصة إبليس، كلا، ولذلك جعل الأمر على غير هذا، أولاً تسلية وتعزية للمسلمين، وثانياً لإمكان المراجعة فإن رجعتم إلى المربع الأول فنصرتم الله عاد إليكم نصره واستطعتم أن تواجهوا عدوكم ولن يكون خذلانكم ولا هزيمتكم إلا جولة ثم تعودون مرة أخرى إلى ما كنتم عليه، وهذا الذي رأيناه أو عرفناه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تاريخ أمتنا كذلك، ثم هذا المعنى مهم لم يصرح بأنه لا ناصر لهم وإن كان مفيد له لهذا المعنى.
ثم أيضاً قال بعض أهل التفسير كلاماً جميلاً هنا: {إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ} قالوا: "إن أول نصر يحققه الإنسان هو نصره على نفسه" فالذي يهزم في معركة نفسه سيكون عنده بشكل من الأشكال أو صورة من الصور شيء من الخذلان؛ لأن النصر هو النصر على العدو وأعدى الأعداء وأقربها إلينا وألصقها بنا وأكثرها تداخلاً معنا هي النفس الأمارة بالسوء التي تدعو إلى اتباع الهوى التي تركن إلى الدنيا ولا تتعلق بالآخرة كل هذه المعاني مهمة، وإن ينصركم الله فحينئذ لن يغلبكم الشيطان ولن تغلبكم قوى الأرض لأنكم انتصرتم على أنفسكم بالإيمان بإيثار ما عنده على ما في هذه الدنيا وسيكون حالكم حينئذ على غير الذي تكونون عليه، فحينئذ ستنصرون على جنود الشهوات وستنصرون على جنود الشبهات وتنتصرون على جنود الأرض والبشر الذين قد يحاربونكم ويواجهونكم.
{فَلَا غَالِبَ لَكُمْ} أي من الناس فلن يغلبكم مع نصره سبحانه وتعالى لكم أحد.
{وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ} من بعده إما من بعد خذلانه أو من بعد الله سبحانه وتعالى وكلا الأمرين معناه قريب وظاهر، وهذا كله يفضي إلى تحقيق يقين المؤمن برد الأمور كلها لله، {وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ}[آل عمران: 126] فكل أمر إذا عرفنا ردّه إلى الله وكان ذلك يقيناً في نفوسنا حينئذ نطلبه دائماً منه سواء بالدعاء أو بالاستقامة حتى عندما نأخذ بالأسباب إذا كان هذا اليقين راسخاً بأن الأسباب لا تؤدي إلى النتائج وإنما الذي يحقق النتائج هو مسبب الأسباب ورب الأرباب سبحانه وتعالى عرفنا أن الأسباب حينئذ هي مجرد أمر مطلوب، أما النتيجة فقد أخذ النبي كفاً من حصى ورمى بها في وجوه القوم فقال: (شاهت الوجوه) فما من أحد إلا وكان فيه أثر منها، وقبل بدر قال: (هذا مصرع أبي جهل، هذا مصرع فلان…) فما تجاوز أحد منهم الموضع الذي عيّنه النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك النبي دعا وأخذ بصف أصحابه وهيأ أسبابه التي كانت أسباباً ضئيلة قليلة كليلة بالمقياس المادي، {وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ} امرأة ضعيفة عند حملها أضعف عند وقت ولادتها أشد ضعفاً تهز نخلة ماذا تصنع بها؟
لكن ماذا كانت النتيجة؟
{تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا} [مريم : 25] هذه أسباب.
ومن هنا ختمت الآية بقوله سبحانه وتعالى {وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ} إذاً هذا المعنى الأول يعطينا اليقين بأن الأمور من الله وهذا اليقين يفيدنا شيئاً مهماً وهو أنه لا يأس من روح الله ولا قنوط من رحمة الله ولا استبعاد لنصر الله: {حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ} [يوسف: 110] وكما قال الحق سبحانه وتعالى في شأن كل البلاء الذي يحصل ويستبطئ بعض المؤمنين النصر لأجله حتى يقولوا: {مَتَى نَصْرُ اللَّهِ} والجواب: {أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ} [البقرة: 214].
{فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (5) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا} [الشرح: 5،6] (لن يغلب عسر يسرين)، وما من ظلام يشتد إلا ويأتي بعده نور الفجر يبدد الظلام فلا بد أن يكون هذا المعنى القرآني يجعل اليقين في قلوبنا، ولذلك قال: {وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ} تقديم الجار والمجرور لتقوية معنى التوكل، ما قال توكلوا على الله؟
فيمن تتوكل على الله أو على غيره لكن {وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ} لا توكل إلا على الله.
والتوكل الحقيقي هو لمن له أسباب التوكل كما قال جل وعلا: {وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ} [الفرقان: 58] مهما توكلت على ملك أو على قوي يمكن أن تدوم قوته لكنه في آخر الأمر سيموت أو لا يموت؟!
{وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ} [الشعراء : 217] العزيز: هو الغالب الذي لا يقهر، لكن الغالب الذي لا يقهر من البشر تتوكل عليه ثم ماذا يحصل؟ قد ينقلب عليك فتكون أنت المعاقب عنده لكن العزيز عنده رحمه سبحانه وتعالى فهو غالب لا يقهر وهو رحيم سبحانه وتعالى بمن يتوكل عليه فلا يكله إلى نفسه لا في السراء ولا في الضراء بل يكون معه سبحانه وتعالى.
{فَلْيَتَوَكَّلِ} والفاء هنا للتعقيب السريع يعني من كان في قلبه يقين بهذا المعنى بأن الناصر الله وأنه إذا نصر من الله فلن يغلبه أحد وأن الخذلان يكون بسبب مفارقة أمر الله وأنه إن خذل من الله فلن ينصره أحد فإنه حينئذ لا يلجأ هنا ولا هناك ولا يبحث عن النصرة في شرق الأرض ولا في غربها ولا في قوى دولية ولا في مؤسسات وإنما حبله موصول بالله كما رأينا دعاء النبي في يوم بدر وكما رأيناه من قبل في دعائه عند خروجه من الطائف وكما رأيناه حتى في يوم حنين وهو يقول: (أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبدالمطلب) صلى الله عليه وسلم، دائماً مع الله {وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ}.
والتوكل أيضاً جاء بصيغة المضارع لدوام التوكل وجاء بصفة الإيمان؛ لأنه هو معقد هذا التوكل، وهذه الآية عاصِمَةٌ لنا في حالنا هذه وفي وقت ضعف أمتنا وفي وقت احتلال أرضنا وفي وقت تسلط أعدائنا نقول: {إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ}.
نسأل الله جل وعلا أن يرد أمتنا إلى دينها رداً جميلاً وأن يجعلنا بكتاب الله مستمسكين وبهدي نبيه صلى الله عليه وسلم معتصمين ولآثار السلف الصالح مقتفين، ونسأله عز وجل أن يؤلف بين قلوبنا وأن يوحد صفوفنا وأن يعيننا على طاعته ومرضاته، وأن ينصرنا على عدونا وعدوه وعدو الإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.
وطرحٌ يستحق المتابعة
شكراً لكِ

دمـتِ برعـاية الله وحفـظه
سلمت يمنياكِ على طرحك القيم
جعله الله في موازين حسناتكِ
اثابك الله