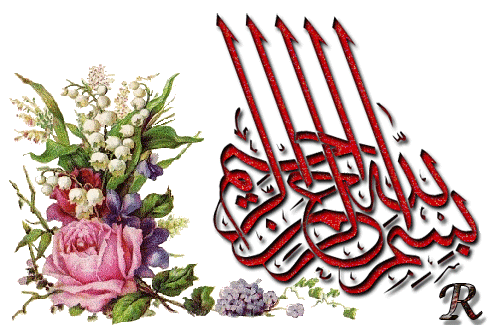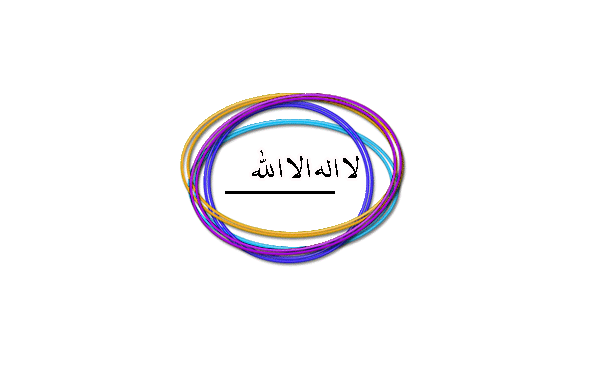قال تعالى:{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } [الأنفال:41]
نقف أمام وصف اللّه – سبحانه – لرسوله – صلى الله عليه وسلم – بقوله:«عبدنا» في هذا الموضع الذي يرد إليه فيه أمر الغنائم كلها ابتداء،وأمر الخمس المتبقي أخيرا:«إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ،وَما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ» ..
إنه وصف موح .. إن العبودية للّه هي حقيقة الإيمان وهي في الوقت ذاته أعلى مقام للإنسان يبلغ إليه بتكريم اللّه له فهي تجلى وتذكر في المقام الذي يوكل فيه إلى رسول اللّه – صلى الله عليه وسلم – التبليغ عن اللّه،كما يوكل إليه فيه التصرف فيما خوله اللّه.
وإنه لكذلك في واقع الحياة! إنه لكذلك مقام كريم .. أكرم مقام يرتفع إليه الإنسان ..
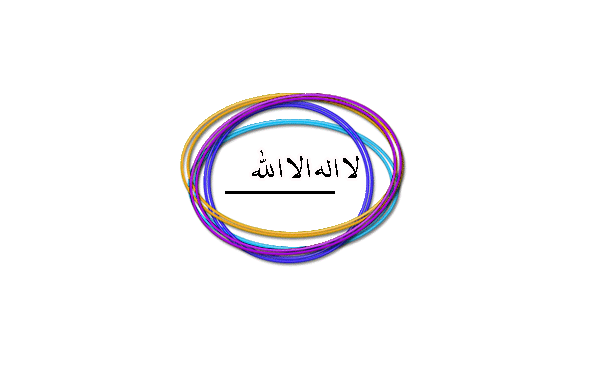
إن العبودية للّه وحده هي العاصم من العبودية للهوى،والعاصم من العبودية للعباد .. وما يرتفع الإنسان إلى أعلى مقام مقدر له،إلا حين يعتصم من العبودية لهواه كما يعتصم من العبودية لسواه.
إن الذين يستنكفون أن يكونوا عبيدا للّه وحده،يقعون من فورهم ضحايا لأحط العبوديات الأخرى.
يقعون من فورهم عبيدا لهواهم وشهواتهم ونزواتهم ودفعاتهم فيفقدون من فورهم إرادتهم الضابطة التي خص اللّه بها نوع «الإنسان» من بين سائر الأنواع وينحدرون في سلم الدواب فإذا هم شر الدواب،وإذا هم كالأنعام بل هم أضل،وإذا هم أسفل سافلين بعد أن كانوا – كما خلقهم اللّه – في أحسن تقويم.
كذلك يقع الذين يستنكفون أن يكونوا عبيدا للّه في شر العبوديات الأخرى وأحطها .. يقعون في عبودية العبيد من أمثالهم،يصرفون حياتهم وفق هواهم،ووفق ما يبدو لهم من نظريات واتجاهات قصيرة النظر،مشوبة بحب الاستعلاء،كما هي مشوبة بالجهل والنقص والهوى! ويقعون في عبودية «الحتميات» التي يقال لهم:إنه لا قبل لهم بها،وإنه لا بد من أن يخضعوا لها ولا يناقشوها .. «حتمية التاريخ» .. و«حتمية الاقتصاد» .. و«حتمية التطور» وسائر الحتميات المادية التي تمرغ جبين «الإنسان» في الرغام وهو لا يملك أن يرفعه،ولا أن يناقش – في عبوديته البائسة الذليلة – هذه الحتميات الجبارة المذلة المخيفة!
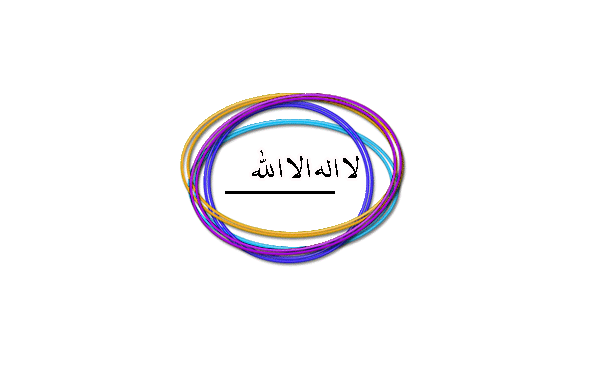
وقال تعالى:«لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ – وَلَا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ – وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعاً.فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذاباً أَلِيماً،وَلا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً».
لقد عني الإسلام عناية بالغة بتقرير حقيقة وحدانية اللّه سبحانه وحدانية لا تتبلس بشبهة شرك أو مشابهة في صورة من الصور وعني بتقرير أن اللّه – سبحانه – ليس كمثله شيء.فلا يشترك معه شيء في ماهية ولا صفة ولا خاصية.كما عني بتقرير حقيقة الصلة بين اللّه – سبحانه – وكل شيء (بما في ذلك كل حي) وهي أنها صلة ألوهية وعبودية.ألوهية اللّه،وعبودية كل شيء للّه ..والمتتبع للقرآن كله يجد العناية فيه بالغة بتقرير هذه الحقائق – أو هذه الحقيقة الواحدة بجوانبها هذه – بحيث لا تدع في النفس ظلا من شك أو شبهة أو غموض.
ولقد عني الإسلام كذلك بأن يقرر أن هذه هي الحقيقة التي جاء بها الرسل أجمعون.فقررها في سيرة كل رسول،وفي دعوة كل رسول وجعلها محور الرسالة من عهد نوح عليه السلام،إلى عهد محمد خاتم النبيين – عليه الصلاة والسلام – تتكرر الدعوة بها على لسان كل رسول:«يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ» ..
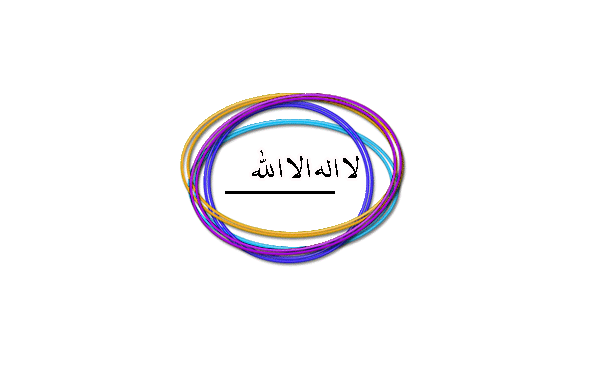
وكان من العجيب أن أتباع الديانات السماوية – وهي حاسمة وصارمة في تقرير هذه الحقيقة – يكون منهم من يحرف هذه الحقيقة وينسب للّه – سبحانه – البنين والبنات أو ينسب للّه – سبحانه – الامتزاج مع أحد من خلقه في صورة الأقانيم اقتباسا من الوثنيات التي عاشت في الجاهليات! ألوهية وعبودية ..ولا شيء غير هذه الحقيقة.ولا قاعدة إلا هذه القاعدة.ولا صلة إلا صلة الألوهية بالعبودية،وصلة العبودية بالألوهية ..
ولا تستقيم تصورات الناس – كما لا تستقيم حياتهم – إلا بتمحيض هذه الحقيقة من كل غبش،ومن كل شبهة،ومن كل ظل! أجل لا تستقيم تصورات الناس،ولا تستقر مشاعرهم،إلا حين يستيقنون حقيقة الصلة بينهم وبين ربهم ..
هو إله لهم وهم عبيده ..هو خالق لهم وهم مخاليق ..هو مالك لهم وهم مماليك ..وهم كلهم سواء في هذه الصلة،لا بنوة لأحد.ولا امتزاج بأحد ..ومن ثمّ لا قربى لأحد إلا بشيء يملكه كل أحد ويوجه إرادته إليه فيبلغه:التقوى والعمل الصالح ..وهذا في مستطاع كل أحد أن يحاوله.فأما البنوة،وأما الامتزاج فانى بهما لكل أحد؟! ولا تستقيم حياتهم وارتباطاتهم ووظائفهم في الحياة،إلا حين تستقر في أخلادهم تلك الحقيقة:أنهم كلهم عبيد لرب واحد ..
ومن ثم فموقفهم كلهم تجاه صاحب السلطان واحد ..فأما القربى إليه ففي متناول الجميع ..عندئذ تكون المساواة بين بني الإنسان،لأنهم متساوون في موقفهم من صاحب السلطان ..وعندئذ تسقط كل دعوى زائفة في الوساطة بين اللّه والناس وتسقط معها جميع الحقوق المدعاة لفرد أو لمجموعة أو لسلسلة من النسب لطائفة من الناس ..
وبغير هذا لا تكون هناك مساواة أصيلة الجذور في حياة بني الإنسان ومجتمعهم ونظامهم ووضعهم في هذا النظام! فالمسألة – على هذا – ليست – مسألة عقيدة وجدانية يستقر فيها القلب على هذا الأساس الركين،فحسب،إنما هي كذلك مسألة نظام حياة،وارتباطات مجتمع،وعلاقات أمم وأجيال من بني الإنسان.
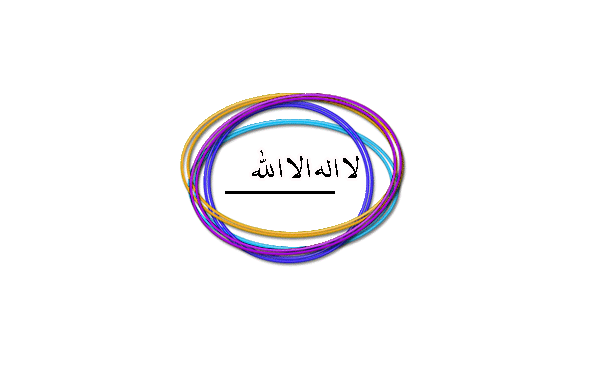
إنه ميلاد جديد للإنسان على يد الإسلام ..ميلاد للإنسان المتحرر من العبودية للعباد،بالعبودية لرب العباد ..ومن ثم لم تقم في تاريخ الإسلام «كنيسة» تستذل رقاب الناس،بوصفها الممثلة لابن اللّه،أو للأقنوم المتمم للأقانيم الإلهية المستمدة لسلطانها من سلطان الابن أو سلطان الأقنوم.ولم تقم كذلك في تاريخ الإسلام سلطة مقدسة تحكم «بالحق الإلهي» زاعمة أن حقها في الحكم والتشريع مستمد من قرابتها أو تفويضها من اللّه!
وقد ظلّ «الحق المقدس» للكنيسة والبابوات في جانب وللأباطرة الذين زعموا لأنفسهم حقا مقدسا كحق الكنيسة في جانب ..ظل هذا الحق أو ذاك قائما في أوربا باسم (الابن) أو مركب الأقانيم.حتى جاء «الصليبيون» إلى أرض الإسلام مغيرين.فلما ارتدوا أخذوا معهم من أرض الإسلام بذرة الثورة على «الحق المقدس» وكانت فيما بعد ثورات «مارتن لوثر» و«كالفن» و«زنجلي» المسماة بحركة الإصلاح ..على أساس من تأثير الإسلام،ووضوح التصور الإسلامي،ونفي القداسة عن بني الإنسان ونفي التفويض في السلطان ..لأنه ليست هنالك إلا ألوهية وعبودية في عقيدة الإسلام .
وهنا يقول القرآن كلمة الفصل في ألوهية المسيح وبنوته وألوهية روح القدس (أحد الأقانيم) وفي كل أسطورة عن بنوة أحد للّه،أو ألوهية أحد مع اللّه،في أي شكل من الأشكال ..يقول القرآن كلمة الفصل بتقريره أن عيسى بن مريم عبد للّه وأنه لن يستنكف أن يكون عبدا للّه.وأن الملائكة المقربين عبيد للّه وأنهم لن يستنكفوا أن يكونوا عبيدا للّه.وأن جميع خلائقه ستحشر إليه.وأن الذين يستنكفون عن صفة العبودية ينتظرهم العذاب الأليم.
وأن الذين يقرون بهذه العبودية لهم الثواب العظيم:«لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ – وَلَا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ – وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعاً.فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ.وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذاباً أَلِيماً،وَلا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً».
إن المسيح عيسى بن مريم لن يتعالى عن أن يكون عبدا للّه.لأنه – عليه السلام – وهو نبي اللّه ورسوله – خير من يعرف حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية وأنهما ماهيتان مختلفتان لا تمتزجان.وهو خير من يعرف أنه من خلق اللّه فلا يكون خلق اللّه كاللّه أو بعضا من اللّه! وهو خير من يعرف أن العبودية للّه – فضلا على أنها الحقيقة المؤكدة الوحيدة – لا تنقص من قدره.فالعبودية للّه مرتبة لا يأباها إلا كافر بنعمة الخلق والإنشاء.وهي المرتبة التي يصف اللّه بها رسله،وهم في أرقى حالاتهم وأكرمها عنده ..وكذلك الملائكة المقربون – وفيهم روح القدس جبريل – شأنهم شأن عيسى عليه السلام وسائر الأنبياء – فما بال جماعة من أتباع المسيح يأبون له ما يرضاه لنفسه ويعرفه حق المعرفة؟!َ مَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعاً»..
فاستنكافهم واستكبارهم لا يمنعهم من حشر اللّه لهم بسلطانه ..سلطان الألوهية على العباد ..شأنهم في هذا شأن المقرين بالعبودية المستسلمين للّه ..
فأما الذين عرفوا الحق،فأقروا بعبوديتهم للّه وعملوا الصالحات لأن عمل الصالحات هو الثمرة الطبيعية لهذه المعرفة وهذا الإقرار فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله.
«وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذاباً أَلِيماً وَلا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً» ..
وما يريد اللّه – سبحانه – من عباده أن يقروا له بالعبودية،وأن يعبدوه وحده،لأنه بحاجة إلى عبوديتهم وعبادتهم،ولا لأنها تزيد في ملكه تعالى أو تنقص من شيء.ولكنه يريد لهم أن يعرفوا حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية،لتصح تصوراتهم ومشاعرهم،كما تصح حياتهم وأوضاعهم.فما يمكن أن تستقر التصورات والمشاعر،ولا أن تستقر الحياة والأوضاع،على أساس سليم قويم،إلا بهذه المعرفة وما يتبعها من إقرار،وما يتبع الإقرار من آثار ..
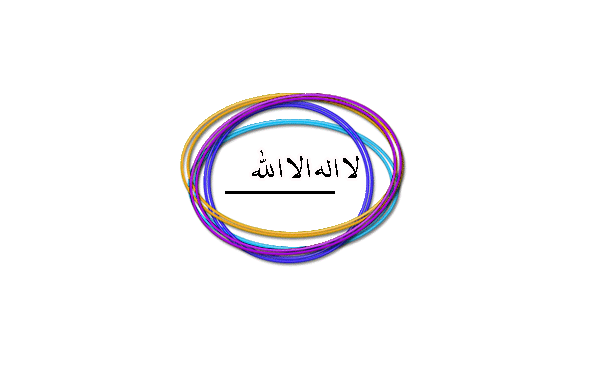
يريد اللّه – سبحانه – أن تستقر هذه الحقيقة بجوانبها التي بيناها في نفوس الناس وفي حياتهم.ليخرجوا من عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده.ليعرفوا من صاحب السلطان في هذا الكون وفي هذه الأرض فلا يخضعوا إلا له،وإلا لمنهجه وشريعته للحياة،وإلا لمن يحكم حياتهم بمنهجه وشرعه دون سواه.
يريد أن يعرفوا أن العبيد كلهم عبيد ليرفعوا جباههم أمام كل من عداه حين تعنو له وحده الوجوه والجباه.يريد أن يستشعروا العزة أمام المتجبرين والطغاة،حين يخرون له راكعين ساجدين يذكرون اللّه ولا يذكرون أحدا إلا اللّه.يريد أن يعرفوا أن القربى إليه لا تجيء عن صهر ولا نسب.ولكن تجيء عن تقوى وعمل صالح فيعمرون الأرض ويعملون الصالحات قربى إلى اللّه.يريد أن تكون لهم معرفة بحقيقة الألوهية وحقيقة العبودية،فتكون لهم غيرة على سلطان اللّه في الأرض أن يدعيه المدعون باسم اللّه أو باسم غير اللّه فيردون الأمر كله للّه ..ومن ثم تصلح حياتهم وترقى وتكرم على هذا الأساس …
إن تقدير هذه الحقيقة الكبيرة وتعليق أنظار البشر للّه وحده وتعليق قلوبهم برضاه وأعمالهم بتقواه ونظام حياتهم بإذنه وشرعه ومنهجه دون سواه ..إن هذا كله رصيد من الخير والكرامة والحرية والعدل والاستقامة يضاف إلى حساب البشرية في حياتها الأرضية وزاد من الخير والكرامة والحرية والعدل والاستقامة تستمتع به في الأرض ..في هذه الحياة ..فأما ما يجزي اللّه به المؤمنين المقرين بالعبودية العاملين للصالحات،في الآخرة،فهو كرم منه وفضل في حقيقة الأمر.وفيض من عطاء اللّه.
وفي هذا الضوء يجب أن ننظر إلى قضية الإيمان باللّه في الصورة الناصعة التي جاء بها الإسلام وقرر أنها قاعدة الرسالة كلها ودعوة الرسل جميعا قبل أن يحرفها الأتباع،وتشوهها الأجيال ..يجب أن ننظر إليها بوصفها ميلادا جديدا للإنسان تتوافر له معه الكرامة والحرية،والعدل والصلاح،والخروج من عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده في الشعائر وفي نظام الحياة سواء.
والذين يستنكفون من العبودية للّه،يذلون لعبوديات في هذه الأرض لا تنتهي ..يذلون لعبودية الهوى والشهوة.أو عبودية الوهم والخرافة.ويذلون لعبودية البشر من أمثالهم،ويحنون لهم الجباه.ويحكمون في حياتهم وأنظمتهم وشرائعهم وقوانينهم وقيمهم وموازينهم عبيدا مثلهم من البشر هم وهم سواء أمام اللّه ..ولكنهم يتخذونهم آلهة لهم من دون اللّه ..هذا في الدنيا ..أما في الآخرة «فَيُعَذِّبُهُمْ عَذاباً أَلِيماً،وَلا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً» ..
إنها القضية الكبرى في العقيدة السماوية تعرضها هذه الآية في هذا السياق في مواجهة انحراف أهل الكتاب من النصارى في ذلك الزمان.وفي مواجهة الانحرافات كلها إلى آخر الزمان .
ــــــــــــــــــــــــــ
من كتاب : مِفْرَقُ الطَّريقِ في القُرآن الكَريم
جمع وإعداد/ علي بن نايف الشحود
غير منقول